محمد بنحمادة
أسئلة للتأمل:
من السؤال نبدأ:
- هل مازالت المؤسسة (السياسية والدينية والتربوية...) قادرة على صياغة حدود للوعي في ظل مجتمع رتب أولوياته؟.
- ألا يؤدي تراجع دور المؤسسة في تشكيل الوعي إلى بروز قوى جديدة تلعب هذا الدور لكن بمقاساتها الخاصة؟.
- هل يمكن الاطمئنان إلى سلامة الدور الذي تلعبه المدرسة داخل المجتمع المغربي؟.
- هل المدرسة مهيأة، من خلال آليات اشتغالها الحالية، أن تكون شريكا في عملية التنمية؟.
- ألا يمكن النظر إلى المدرسة، بوضعها الحالي، باعتبارها عاملا من عوامل خلق اللاتوازن داخل المجتمع؟.
كلها أسئلة نضعها للتأمل فحسب، بعيدا عن ادعاء القدرة على الإجابة عنها إجابة دقيقة فاحصة، لأن ذلك في تقديري يتطلب فريق عمل كل من جانب تخصصه، كما يستلزم جهدا وإرادة ليسا متوافرين، وحسبنا من هذه المحاولة أن نفجر السؤال وذلك لاقتناعنا أن ما يشكل الدرس الأساسي للحياة ليس هو الإجابات القاطعة الجازمة، وإنما فعل السؤال الذي يفتح التجربة الإنسانية على عوالم غير متوقعة.
المدرسة والمجتمع: سؤال التناغم المؤسساتي.
إن أقصى ما يطمح إليه كل تجمع بشري (في كل زمان وفي كل مكان) هو بلوغ حالة من الرقي والتحضر تسمح له بتأمين موقعه داخل عالم لا مقعد فيه للضعفاء، ولهذه الغاية فكل مجتمع يجند طاقاته وإمكاناته، ويوجِدَ لنفسه صيغا وآليات تتكاثف وتتفاعل لتبني لهذا الأفق حدوده وترسم للمجتمع امتداداته.
على أن تحصيل فعل الرقي يستلزم بالضرورة نوعا من "التنظيم المؤسساتي" توزع بموجبه الأدوار لكن في إطار بنية عامة وكلية تعبر عن خصوصية المجتمع وعن طموحاته الخاصة، فسؤال التنمية تنخرط في تفعيله والإجابة عنه كل البنى المؤسسة للمجتمع، فالتنمية هي حصيلة طبيعية لتناغم المؤسسات وتجانس أدوارها، فلا مجال لتحقيق طفرة اقتصادية أو اجتماعية بمعزل عن انفتاح سياسي، أو بمنأى عن توفر غطاء ثقافي وفكري تنسج المؤسسات التعليمية والتربوية خيوطه، وكل تنمية لا تعبر عن هذا التناغم المؤسساتي لن تكون سوى إفرازات شاذة من الصعب المراهنة عليها كبدائل حقيقية.
إن التساؤل حول دور المدرسة في التنمية يجب أن يكون مسبوقا بسؤال آخر تعتبر الإجابة عنه مفتاحا للإجابة على السؤال الأول، والأمر يتعلق برصد الموقع الذي تحتله المدرسة داخل نسيج المجتمع، ونستطيع القول بصيغة أخرى إن سؤالنا ليس دور المدرسة في التنمية، ولكن ما هي الإمكانات المتاحة للمدرسة كي تساهم في هذه التنمية ؟.
فالتركيز على السؤال الأول يشعرنا بداهة بأن نظامنا التعليمي يتمتع بعافية تخول له الانخراط في تفعيل المشروع التنموي، كما يشعرنا أيضا بأن هناك تناغما بين مؤسساتنا التعليمية وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تشتغل في إطاره، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فقد أصبحت المدرسة كيانا معزولا عن محيطها السوسيواقتصادي، وقد قادتها عزلتها إلى إفراز أعراض جانبية سلبية، فبدلا من أن تلعب دور الخزان الذي يدعم كل القطاعات بالطاقات الفكرية والبشرية أي القاعدة التي تتكون فيها الفئات المهيأة باستمرار لتحمل المسؤولية، غدت مصنعا لتفريخ الطاقات المهدرة، ومعملا لإنتاج البطالة وتوسيع دائرة الناقمين والمهمشين، وهو ما أضعف هذه المدرسة وحول موقعها من مركز التجربة الإنسانية في المجتمع المغربي إلى هامش هذه التجربة، فالمدرسة في التداول اليومي غدت أشبه بمغامرة يخوضها الآباء مع أبنائهم (هي مغامرة لا متعة فيها)، ويمكننا قياس درجة هذه المغامرة من خلال تعليقات المجتمع (طَفْرُوهْ الِلّي قْرَاوْ )، (رْمِي لْكْتُوبَة وْدَبَّرْلكْ عْلَى خدْمَة)، (اللِّي قْرَا قْرَا بَكْري)، (كُونْ غِيرْ سَدُّوهَا – أي المدرسة – وْهَنَّاوْنَا)....
إن هذا التراجع هو أمر طبيعي، فالمجتمع قد رتب أولوياته تحت ضغط الحاجة، ففي مجتمع اقترب الخبز فيه من الحلم أو ارتبط بالعسر ومشقة التحصيل، وباتت فيه إكراهات الواقع بما تمليه من ضرورة المقاومة من أجل العيش والبقاء، الموجِّه الأول للسلوك الفردي والجماعي، والمحدد الحاسم لاختيارات الناس وردود أفعالهم، سيكون من الصعب على المدرسة أو أي مؤسسة أخرى دينية كانت أم سياسية أن تشكل وعي الناس، فقوة الأفكار تراجعت لصالح قوة جديدة هي قوة الواقع ( قوة الخبز )، فالجائع لا تثيره أناشيد الحصاد ولا صور السنابل الذهبية في الكتب المدرسية، فآلاف الأفكار والصور لا يمكنها أن تعادل رغيفا واحدا من الخبز.
وهكذا لم تعد المدرسة تشكل مركز التجربة الإنسانية في المجتمع المغربي، ولم تعد المحور الذي يشد إليه طموحات الناس واهتماماتهم، بل تحول هذا المركز إلى مجموعة من مناطق الظل التي عششت فيها كائنات شوهتها عزلتها وغيرت طبائعها، وبنت لوعيها حدودا جديدة. وبما أنه لا وجود لفكر فارغ، فسيكون لزاما علينا تحديد نوع الامتلاء الذي نريد.
المدرسة والمجتمع: آليات الاشتغال وسؤال المردودية.
لا يمكن الإجابة عن سؤال المردودية إلا من خلال رصد آليات الاشتغال، وعليه فتصور مدرسة قادرة على الإنتاج وقادرة على المشاركة في تفعيل عملية التنمية، يستوجب بالضرورة توفير الإمكانات الضرورية واللازمة لهذه المدرسة حتى تقوم بوظيفتها تلك، فهل تتمتع المدرسة المغربية بهذه الآليات والميكانيزمات؟.
إن الملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها هنا هي أن نظامنا التعليمي يعاني من عزلة، فهو محاصر داخل القاعات والمدرجات، فالتلميذ أو الطالب المغربي مفصول كليا عن العالم الخارجي، عالم الفعل والانفعال، عالم الواقع والوقائع والتجربة الحسية، إنه مسجون داخل حزم من الأفكار المجردة والمحرومة من كل اتصال مع التجربة الحسية المباشرة، ونحن لا نشكك في قدرة الأفكار على تشكيل الوعي أو تحريك التجربة الإنسانية، لأن ما ندركه باعتباره واقعة هو في الواقع امتداد حسي لفكرة موغلة في التجريد.
غير أن الوجود المعزول للأفكار والنظريات والمناهج يجعل من حاملها كائنا ينظر إلى العالم وحياة الناس من جانب تجريدي ودون أن تكون له القدرة على تحريك هذا الإدراك واستثماره في الحياة العملية. إن خريجا بهذه المواصفات سرعان ما يكتشف عجزه عند أول اتصال بالعالم الخارجي، إن هذا النوع من التعليم يقود إلى إدراك الأشياء وتحصيلها بعيدا عن الفهم الصحيح والدقيق، فعالم الواقع والتجربة المباشرة هو المجال الأنسب لقياس درجة سلامة الأفكار أو عدم صلاحيتها، وهو إلى ذلك مهد النظرية ومصدر انبثاقها، وهو أيضا المجال المستهدف بهذه الأفكار، فالنظرية التي لا تروم الإمساك بواقع ما لأجل تغييره أو تعديله، تبقى نظرية عقيمة لا يمكنها أن تكون سوى محبس تحاصر الذات المتعلمة داخله.
وهكذا فالاستناد إلى الأفكار التي لا مجال لتصريفها أو تفعيلها على مستوى التجربة الحية يقود الذات بالضرورة إلى نوع من العزلة (وكثيرا ما نتحدث عن غربة المثقف) التي يمكنها أن تسفر في حدودها القصوى عن أشكال متعددة ومتطرفة من الشذوذ " فاكتساب المعارف التي لا يمكن استخدامها هو الوسيلة المؤكدة لتحويل الإنسان إلى متمرد " )غوستاف لوبون ـ سيكولوجية الجماهير(.
فتعليمنا بمناهجه وميكانيزماته الحالية يصنع من خريجيه ذوات شاذة، وهو بذلك يقدم مادة أولية يستطيع الشذوذ أن يمفصلها ويقطعها على مقاسات عدة (التطرف، والانحراف، وأشكال العبث واللامعقول...). إننا بهذا التعليم نصنع للمجتمع أعداء من حيث لا ندري وذلك من خلال توسيع دائرة المهمشين والمعطلين الناقمين على أوضاعهم والمهيئين نفسيا واجتماعيا للتمرد والانخراط في أبشع أنواع التطرف والانحراف، وهو ما يجعلنا أمام خسارة مزدوجة، فمن جهة تم إهدار جهد كبير وتبذير أموال طائلة من أجل شحن عقول الناس بأفكار مشلولة وعقيمة، فلا أحد يستطيع أن يبرهن على أن تعليمنا بآليات اشتغاله الحالية يمكنه أن يجعل الإنسان أكثر ذكاء أو أجود مردودية وإنتاجا، وكم سيكون مخيبا للأمل أن نحصي نخبتنا المثقفة الحاملة لمشاريع فكرية حقيقية، فالرقم سيكون حتما هزيلا جدا إلى الدرجة التي تدفعنا إلى التساؤل: ماذا كنا نفعل من الاستقلال إلى الآن ؟ ماذا كان دور المدرسة على امتداد هذه الفترة الطويلة ؟، وحتى هذا الرقم الهزيل لا يمكن الاستناد إليه من أجل تمجيد الذات والاحتفاء بها، فمعظم مثقفينا هم نتاج مؤسسات أجنبية أو في أحسن الأحوال مؤسسات خاصة، وسيكون مخيبا للأمل أيضا أن تحتل المناصب والمراتب الحساسة من قبل طاقات قادمة من الضفة الأخرى، وهو ما يشكل وجها آخر لعجز نظامنا التعليمي وانفصال المدرسة عن محيطها وعدم صلاحية برامجها لقيادة المجتمع وتنميته.
نستطيع القول إن من سلبيات هذا التعليم أنه يقود إلى شيخوخة فكرية قاتلة، فهو يركز على شحن المتعلم في كل مراحل الدراسة ومحاصرته بزخم من المعلومات والمواد التي يجهد نفسه في تخزينها ثم استحضارها في لحظات الامتحانات، وهو ما يفقده كل قدرة على تفعيل ملكاته النقدية، فوظيفته محصورة في ابتلاع المضامين والأفكار (وربما الأشكال أيضا)، وحفظ القواعد والملخصات المعدة سلفا من قبل الأساتذة، وهذا ما يشكل ثقافة سلبية )ثقافة ما يسمى" بضاعتنا ردت إلينا" (تجعل من الباث (الأستاذ) كيانا مقدسا ومالكا لحقيقة يؤمن بمطلقيتها، وتصنع من المتلقين (التلاميذ والطلبة) كيانات مستهلكة ونسخا مشوهة، أو ربما صدى باهت لأساتذتهم، وهذا ما ساهم في خلق حالة من الثبات الناتج عن استنساخ النموذج نفسه وإخضاع الأجيال له، وهو ما أدى حتما إلى خفض مستوانا وجعلنا في حالة عجز دائم.
وأما الوجه الثاني لهذه الخسارة فيمكن التأكيد من خلاله على أن تعليمنا بمناهجه الحالية قادنا إلى خلق حالة من عدم التوازن داخل المجتمع، فطوابير المعطلين الناقمين تمتد كل لحظة، والدولة عاجزة عن تلبية مطالبهم فهي تشغل عددا صغيرا منهم، وتترك الآخرين عرضة للعطالة، وهي بذلك تعطي فرصة لقوى أخرى تشتغل في الظل لكي تحتوي هذه الأعداد من الخريجين المهمشين الناقمين ولكي تعيد تشكيل وعيهم وفق استراتيجياتها الخاصة، وهكذا لم تعد وظيفة المدرسة خلق حالة من التوازن داخل المجتمع من خلال تكوين مواطن قادر على الإجابة على أسئلة عصره، ومن خلال تشكيل وعي يستجيب لخصوصيات المجتمع، بل أصبحت هذه المدرسة نفسها عنصرا أساسا من عناصر خلق اللاتوازن داخل المجتمع.
جهة نظر:
نقول إن إصلاح التعليم لا يجب أن يركز فقط على المدرسة في ذاتها أي على المناهج والكتب المدرسية وإحداث المؤسسات وتجهيزها، وإنما عليه أن ينحو منحى المقاربة الشمولية التي تبحث عن الخلل داخل بنية كلية تشكل المدرسة داخلها نظاما فرعيا، ومثل هذه المهمة تستوجب بالضرورة صياغة مشروع شامل يضع في اعتباره العلاقات بين القطاعات والمؤسسات المشكلة لنسيج المجتمع، ولا يكفي في ذلك عزل قطاع واختصاصه بترميمات ستصبح فيما بعد عائقا حقيقيا أمام التنمية لا مفعلا لها، كما يجب أن يضع في اعتباره الخصوصيات الثقافية والاقتصادية والسياسية والجغرافية، لأن المدرسة في النهاية هي المجال الأنسب لتكريس هذه الخصوصيات والدفاع عنها، وهي أيضا الخزان الذي يمد هذه القطاعات بالإجابات الشافية على مجموع الأسئلة المقلقة التي راكمتها هذه القطاعات (بدل الإجابة على هذه الأسئلة من خارج الذات).
وهكذا سيكون من باب التبسيطية والسذاجة النظر إلى المدرسة في بعدها المعزول أي اعتبارها مؤسسة مقطوعة الصلة عن باقي المؤسسات الأخرى، إنها من حيث وجودها كمؤسسة لها نظمها وقوانينها فهي تتمتع بكثير من الاستقلالية، لكنها من حيث كونها شريكا في عملية التنمية، وشريكا في مشروع مجتمعي وحضاري فهي تحظى بروح تفاعلية تجعل منها بنية صغيرة داخل بنية أكبر هي المجتمع بكل مؤسساته ( السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية.. ).
وعلى هذا الأساس فالمدرسة في حاجة إلى إصلاح دائم ومتواصل وذلك من جهتين، من جهة برامجها وآليات اشتغالها، ومن جهة وصلها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يؤطرها، على أن الفصل بين الإصلاحين هو فصل إجرائي فقط، ذلك أن صياغة حدود جديدة للبرامج والمناهج وآليات الاشتغال هو في الأصل استجابة لحاجيات المحيط، وبعبارة أخرى إن إصلاح المنظومة التعليمية يمر أساسا عبر توفير قاعدة تشتغل باعتبارها تجميعا موضوعيا لأسئلتنا المقلقة المراد الإجابة عليها، وتحديدا لحاجاتنا وبياضاتنا المراد سدها وملؤها، إنها قاعدة مستمدة أساسا من المحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعتبر في نهاية المطاف المستهدف الأول والوحيد من فتح المدارس وتعليم الأجيال.























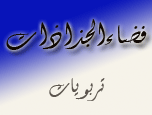
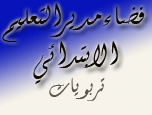

















 عبد اللطيف مشكور
عبد اللطيف مشكور






















